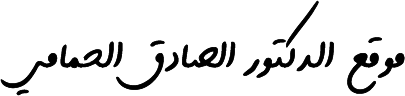“ديمقراطية مشهدية”. الميديا والاتصال والسياسة في تونس”، دار محمد علي الحامي للنشر، تونس 2022
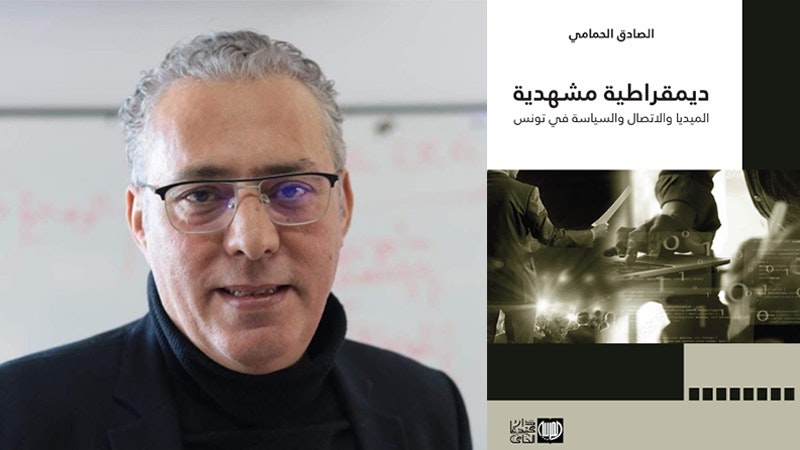
يتناول هذا الكتاب موضوعًا مخصوصًا يتمثّل في دراسة الانتقال السياسيّ في تونس من منظور الاتّصال الصحافة والميديا والاتّصال السياسيّ. وجدير بالذكر أنّ هذا الموضوع لم يحظ بالقدر الكافي من البحث والتحليل رغم الأهمّية التي يحتلّها في الخطاب السياسيّ وفي الخطاب الصحفي المهني وحتى لدى عموم التونسيّين. ولا بدّ من الإشارة هنا أنّ هذا الكتاب لم يحظ بأي نوع من الدعم المؤسّسي لإنجازه، فهو ليس نتاج طلب مؤسّسي بل تجسيد لرغبة الكاتب في المساهمة في الإنتاج المعرفي حول مسائل تمثّل قضايا جوهريّة وأساسيّة.
والكتاب هو خلاصة ما قمنا به من بحوث منجزة أو بصدد الإنجاز في أطر أكاديمية، وامتداد لمقالات نشرت في الصحافة التونسيّة أو العربيّة، ولعدد من المحاضرات في ندوات علميّة وطنيّة ودوليّة (2011-2021) . وهو يشمل كذلك أفكارا وفرضيّات تضمّنتها بحوث نشرت في مجلاّت أكاديميّة في تونس وخارجها، أردنا طرحها للنقاش لأنّ البحث العلمي لا معنى له إذا بقي حبيس الفضاءات المغلقة. كما يمثّل هذا الكتاب امتدادًا لانخراطنا وفق أشكال متعددة في مجال الميديا في تونس كتابة وتدريباً وتدريسًا أو إدارة. وهو أخيراً خلاصة تأمّل في مجال الصحافة والميديا والاتّصال السياسيّ بشكل خاصّ وفي مسألة الديمقراطية بشكل عامّ وبحثاً في تحوّلاتها. وعلى هذا النحو، فهذا المؤلّف يعدّ مزيجاً من التحليل النظري والبحث الميداني وجمعاً بين الأسلوب التفسيري وما يمكن أن نسمّيه المقاربة العمليّة المتّصلة بالصحافة والميديا والاتّصال السياسيّ، فذلك رغبة منا في أن يكون للقارئ التونسي والعربي نظرة شاملة على مسار «الانتقال السياسيّ التأويلية. وإذا أردنا أن يكون هذا الكتاب شاملاً للمشكلات النظريّة والقضايا العمليّة المتّصلة بالصحافة والميديا والاتّصال السياسيّ، فذلك رغبة منا في أن يكون للقارئ التونسي والعربي نظرة شاملة على مسار الانتقال السياسيّ
وهذا الكتاب، بما أنّه نظر في مسائل الصحافة والميديا والاتّصال في علاقتها الوطيدة بالتحوّلات السياسيّة التي عرفتها تونس في العقد الماضي فهو أيضاً تحقيق في مسار تطوّرات الديمقراطية التونسيّة الناشئة. ولا ضير من الإشارة هنا إلى أنّ مسار هذا الكتاب قد شهد عدة تطوّرات ومنعرجات. لقد كنا منشغلين عندما انطلقنا في تأليف هذا الكتاب، بدراسة الميديا التونسيّة في إطار ما يسمّى “الانتقال السياسيّ” ثم تطوّر المشروع تدريجيا نحو مشكلة أشمل، وقد تكون أعمق أيضاً، تتّصل بالعلاقة بين الميديا والاتّصال والديمقراطية التونسيّة. فعندما كنا نفكّر في تحوّلات الصحافة والميديا ونبحث فيها، كانت مسألة السلطة والسياسة حاضرة بشكل خفيّ أحياناً وبشكل جليّ
أحياناً أخرى. فالميديا يُنظر إليها باعتبارها سلطة ذات قدرات على التأثير في الاتّجاهات والمواقف والأفكار. أمّا الصحافة فيعتبرها ممارسوها “سلطة رابعة ” تراقب وتحاسب السلطات الأخرى أو هكذا يطمحون إلى أن تكون. وبشكل عام يشمل الكتاب محورين أساسيّين. يتعلّق المحور الأول بتحوّلات مجالي الصحافة والتلفزيون، في حين يتناول المحور الثاني بالبحث والتحليل مسائل الاتّصال السياسيّ، إضافة إلى محور ذي طابع نظري ومفاهيمي دون مغالاة في الأمور “الإبستيمولوجية”، لأن الكتاب يرنو أيضاً إلى أن يكون مقروءًا من الجمهور العريض الذي يريد أن يفهم مسائل الصحافة والميديا والاتّصال وعلاقتها بالسياسة. وعلى هذا النحو فإنّ الكتاب يتناول في إطار هذه المحاور التي كنّا بصدد الإشارة إليها المسائل التالية:
- في الفصل الأوّل، نتناول بعض المسائل النظريّة والمنهجية أو الإبستيمولوجيّة المتّصلة بدراسة الصحافة والميديا في سياق الانتقال السياسيّ ونتعرّض إلى النقاش العلمي والبحثي حول المشكلات النظريّة
والمنهجية التي تطرحها دراسة الميديا في الانتقال السياسي.
- وفي الفصل الثاني نعالج تحوّلات الصحافة، ساعين في ذلك إلى تجاوز المقاربة التقليدية السائدة التي تكتفي بدراسة تحوّلات الأنظمة القانونيّة وكذلك المقاربة السردية التي تكتفي أيضاً بسرد الأحداث التي شهدها قطاع الصحافة والميديا، دون رؤية نظريّة جامعة ذات قدرة تفسيريّة. ومن المسائل التي سنتناولها في هذا المضمار تحوّلات الصحافة من خلال مداخل “الإيديولوجية الصحفية ” وأزمة الصحافة المطبوعة والمبتكرات الجديدة على غرار التعديل الذاتي وآليات المساءلة والعلاقة بالجمهور والأخلاقيات الصحفية والمصادر وظهور فاعلين جدد في القطاع.
- ويتعرّض الفصل الثالث من الكتاب بشكل مخصوص إلى موضوع التلفزيون وتحوّلاته و “سلطاته” الجديدة وآليات تنظيمه المبتكرة والفاعلين الجدد فيه على غرار ما يسمّى “الكرونيكور”
- ويطرح الفصل الرابع قضايا الاتّصال السياسيّ المختلفة ومنها تطوّر أساليب الاتّصال منذ الاستقلال إلى اليوم وظهور الممارسات الجديدة في التسويق السياسيّ الانتخابي وأدوار الميديا في هذا المجال على غرار المناظرات التلفزيونيّة. ويهتمّ هذا الفصل كذلك بمباحث جديدة على غرار الاتّصال الرئاسي.
- وفي الفصل الخامس نتناول مسائل الاستقطاب الإيديولوجي وظاهرة الشعبويّة باعتبارها أسلوباً في الاتّصال السياسيّ ومكانة المشاعر في الحياة السياسيّة وتوظيفها لتقنيات التسويق السياسيّ.
- أمّا في الفصل السادس فيعالج الكتاب مسألة المجال العموميّ التونسي الجديد عبر عدة مداخل منها مشروعية المفهوم وأهميته في السياق التونسي. ومكانة الميديا في تنظيم المجال العموميّ السياسيّ. وفي الفصل السابع نسعى إلى استخلاص أهم الدروس النظرية عن الاتصال السياسي والميديا في الانتقال السياسي، بالتركيز على فرضية التهجين التي تسمح بفهم التحولات التي طرأت على الصحافة باعتبارها مهنة وعلى الميديا باعتبارها مؤسّسة بالتخلي عن مقاربة الانتقال من القديم إلى الجديد لصالح فهم التفاعلات بين القديم والجديد…
ونستعرض أخيراً في الفصل الثامن الفرضيّة الأساسيّة التي يفضي إلى بلورتها الكتاب وتتمثّل في أن الميديا والاتّصال سَاهَمَا بشكل حاسم في تحويل الديمقراطية التونسيّة إلى “ديمقراطية مشهديّة” تمارس فيها السياسة بشكل مشهدي ويستخدم فيها السياسيّون أنواعا متباينة من الاتّصال قائمة على الإثارة والصداميّة والعدوانيّة والفرجويّة وتتبوّأ فيها “الشخصيات التعبيرية ” التي تجيد فنون الاتّصال الأدوار الأولى.